المحتويات
تطبيق ثورة اثينا واحتلال البطالمة والرومان لمصر
«الرجال يثورون بدافع الغضب لا بدافع الطموح.»
(أرسطو)
ما قبل المقدمة:
بكلماتٍ بسيطة للغاية نستمر في إدراك فلسفة الثورات في الحضارات المختلفة بعدما أوضحنا في الجزء السابق: «مدخل إلى فلسفة الثورات»، ماهية فلسفة الثورات وتكوينها في الحضارة المصرية القديمة مع انتقال طاليس لمصر للدراسة وانتقاله إلى اليونان مؤسسًا الفلسفة كعلم ووجود ننتقل معه بمقالاتنا.
اليوتوبيا والديستوبيا والثورة:
في سياق تاريخي فلسفي، ومن بلاد تدوين الفلسفة نبحث في فلسفة الثورة في الفكر اليوناني، ورغم معارضة أرسطو وسقراط للثورة بإعتبارها فعل داني (من طبقات دنيا)، فإن يوتوبيا أفلاطون –الناتجة من تحليل أفلاطون لأفكار سقراط في الدستور والدولة- هي حالة ما بعد ثورية ولعلها النواة الأولى في دراسة فلسفة الثورة بعد مؤلف «السياسة»؛ لأرسطو فهو لم يناقش التفكك أو التحلل الاجتماعي فقط، بل ناقش أنماط التغير السياسي ومدعاة قيام ثورة في اليونان القديمة من خلال كتابيه «الأخلاق النيقوماخية» و«الفيزياء والميتافيزيقا»، أوضح فيهما أن صورة أي إنتاج تعود لأربع أسباب: مادية وصورية وفاعلة ونهائية، وبتطبيق نظريته في مفهوم السياسة والجمهورية فجعل المواطن هو السبب المادي للوجود والدستور هو السبب الصوري، أما السبب الفاعل فهو الحاكم، والسبب النهائي هو الدولة العادلة كهدف أصيل للدولة، وأن التغيير السياسي يكون من خلال الأسباب الأربعة بتحديد المعلولة السببية ومعالجتها وقد أوضح أن مدعاة قيام ثورة هو اختلال بالأسباب الأربعة أو أحدها.
والخلاصة أن الدولة «الهيولومورفية(*)» دولة مركبة تتكون من مواطن ودستور وحاكم وهدف، وحسب دستورها يكون هدفها وإن أفضل دستور -حسب أرسطو في كتابه- هو الذي يضمن حقوق كل المواطنين مع مراعاة الفروق بين الأحرار والعبيد وبين الرجال والنساء وتكون بضمان الفضيلة الأخلاقية لكل مواطن مع مراعاة ضرورة تعليم كل مواطن وهو ما اعتبروه كنظام يوتبياوي حالم ولا يمكن تحقيقه، ولذا كان ثان أفضل دستور هو الجامع بين الديمقراطي والأوليغارشي أو المعني بتدرج الطبقات، بما يحافظ على ثبات المجتمع وبأن تكون الغلبة للطبقة الوسطى لأنها المحافظة على الكيان للدولة، وإنه إن لم يتحقق العدل أو تواجد الطبقة الوسطى بكثافة فسيؤدي لإنهيار الكيان الخاص بالدولة من خلال التزعزع البنائي للدولة وإصابتها بالمرض العضال بالنسبة للفكر اليوناني المسمى حاليًا بالثورة.
من الثورة إلى اليوتوبيا:
أما أفلاطون فبعدما تمت إدانة أستاذه سقراط، وإجباره على تجرع السمّ الزعاف راح أفلاطون يطرح العديد من التساؤلات التي تؤسس منهجية الدراسة الفلسفية للحراك الجماهيري ضد تعنف السلطة فقال: «كيف يمكن لحكومة منتخبة ديمقراطيًا أن تقتل أفضل البشر؟ ألا يعني ذلك أن هناك مشكلة في تصورها للحكم ثم بشكل أخص للخير والشر؟ أليس من الشر أن نقتل الفيلسوف الحكيم الذي كرس حياته لتوعية البشر وتربيتهم وتثقيفهم؟ ألم يكن قلب سقراط مفعمًا بحب الخير للدولة والمجتمع وكل أبناء الشعب دون استثناء. فلماذا قتلوه إذن؟
هكذا يوضح أفلاطون مدعاة قيام ثورة أو مدعاة التغيير، وهي منهجية إرساء القواعد العادلة أو التدخل الطبيعي نتيجة الانحراف ضد مسيرة العدالة. ثم عممّ سؤاله بأن جعل من سقراط؛ سقاريط (جمع سقراط) في الوطن قد لاذوا بما لاذ به سقراط، كصورة تخيلية بأن جعل من وضع سقراط عدد أفراد الشعب وبأنه ماذا يمكن أن يحدث لو انتشر فكر سقراط وشخصه، عندئذ كيف ستكون صورة النظام؟.
فوجد أن «منهجية التعامل» أن الجسد السلطوي أصم عما يريد الفرد داخل الكيان مؤسسًا بداخله تنازع يؤدي لعلة جسد النظام وما إن تظهر أعراض العلة حتى يسعى الجسد السلطوي بطرد العلة بدلًا من إصلاحها.
وبحسب الفكر الفلسفي الممنطق لهذا الطرح فيمكننا القول بأن تعريف الثورة أنها مرض اكلينيكي حتمي ناتج عن ممارسات خاطئة أصابت الجسد(النظام/المجتمع) بعلة والعلة نتيجة طبيعية يجب معالجتها بمتتالية سياق ديمقراطي. ومن أهم أسباب قيام الثورة هي غياب العدالة.
فنجد أن مفهوم العدالة عند «أرسطو» يتجلى بوضوح في كتاب السياسة بقوله: الأفضل للإنسان أن يحكمه مبدأ عدل إلهي، ويجب أن يكون ذلك المبدأ في داخله كلما أمكن.
وهذا ما تعلمه الإسكندر منه فاستخدم هذا المبدأ في نمطية سيطرته على الحكم في مصر.
كما صرح بأن «رجل الدولة الديموقراطي حقًا يجب أن يدرس كيفية إنقاذ الأغلبية من الفقر المدقع» وأصر على أنه «يجب تدبير كل الإجراءات التي تجلب الازدهار الدائم للجميع وإلا فعواقبها مدمرة»
الفكر الأرسطي في اليوتوبيا المنطقية:
كان أرسطو عازمًا على الدعوة لإعادة توزيع الثروة على أساس أن هذا سيكون أفضل للدولة وللأمة ككل. حتى أنه أفصح عن كيفية حدوث هذا فكتب أن النهج الصحيح هو جمع كل إيرادات الدخل في صندوق واحد وتوزيعها كحصيلة واحدة كأحد طرق تجنب الثورة.
أرسطو أيضًا قد اعترف بأن عدم القدرة على التأثير السياسي ينشر الغضب والعدوانية والعنف ولا يمكن السيطرة على رجل غاضب أو توقع أفعاله.
في نهاية المطاف؛ فقد كتب:
«يقوم الناس بالثورات عندما يُحرَمون من المكانة، وإذا عوملوا بظلم أو بإهانة»
«الرجال الغاضبون يثورون بدافع الانتقام وليس بدافع الطموح»
وطرح السؤال البلاغي: «كيف يمكن للأفراد اللذين لا يشتركون في حكم دولة أن يكونوا ودودين تجاه دستورها؟».
وكانت الإجابة بالنفي بالتأكيد.
لذا في الأساس كان أرسطو يرى أن الناس -الرجال بالنسبة له- المستبعَدين من النفوذ السياسي، يلجأون في نهاية المطاف إلى العنف وهو عنف مبرر نتيجة قمع داخلي.
في وقت لاحق، كرر نيقولا ميكيافيلي (1470-1587) وجهة نظر أرسطو ، عندما أكد؛ «أنه من الضروري أن يكون للجمهوريات قوانين تمكِّن أغلبية المواطنين من التنفيث عن حالة العداء التي يشعرون بها، لأنه عندما لا توجد مثل هذه الآلية، سوف يتم استخدام أساليب خارج القانون، ودون شك، فهذه سيكون لها عواقب أسوأ بكثير من تلك القانونية» (الحوار، 1531، ص102).
لذلك يعتقد أرسطو أنه للحفاظ على نظام سياسي سلمي، من الضروري إشراك جميع المواطنين، وهكذا يترسخ النظام السياسي لأن أولئك الذين يكونون في السلطة يعاملون أولئك الذين هم خارج المؤسسة بشكل ما «عبر ضم رجالهم البارزين إلى مؤسسة الحكم»،
قد يبدو ذلك مثاليًا وساذجًا، غير أنه ليس كذلك، فهو مبدأ نراه في كل السياسات حتى الإجتماعي منها.
وبذلك تتجلى فلسفة الثورة عند أرسطو في الأسس التي لا تؤسس ديموقراطيته الدستورية إنما أسس فكره الكتابي ومدرسته عند الاسكندر.
علل الثورات:
وهذا يتضح في القسم الثامن من كتابه «السياسية»، حيث علل الثورات بناء على شكل أنظمة الحكم، فهناك علل الثورات في الأولغرشيات وعلل الثورات في الديمقراطيات، وغيرها من أشكال الحكم (كنظام الحكم في قرطبة) حيث وضح من خلال طرحه أن هناك علل مسببة للثورات تختلف باختلاف شكل الحكم وباختلاف دستورها وبيئة الشعب ومدى ثقافتهم ومعرفتهم بحقوقهم.
لكنه قد وضع علة عامة للثورات في مختلف الدساتير،
وهي: اللامساواة،
كمسبب أساسي وعام للثورات،
حيث عبر عن ذلك بقوله
«اللامساواة تلك هي العلة العامة بل يمكن أن يقال أنها ينبوع الثورات…».
وفي أثينا رغم أنها مؤسسة ديمقراطية إلا أنها اتسمت بالطبقية فقد كان قاصرًا على طبقة محددة وفي مناطق معينة وبالتالي فلا توجد عدالة اجتماعية وقد أفضت إلى ثورة اجتماعية(انتفاضة) فشكل الصناع والتجار من الطبقة المهمشة والملغاة من الحقوق ونظرًا لكثرة عملهم لتوفير سبل المعيشة فلم يتسن لهم إنشاء جبهة سياسية تدافع عنهم إلا أنهم قد عارضوا نظام الحكم الطبقي وسعوا إلى تغييره بمباديء رجال غاضبون فقط دون أيديولوجية وهذا ما أفضى إلى جعل مجهودهم دون طائل، فتعاملت معهم السلطة بمنهجية القتل الروتيني فرفعت من سبل المعيشة داخل السياق المجتمعي، وقللت من فرص عملهم داخل العاصمة كما استبدلتهم بالعبيد الأرخص ثمنًا، مما أدى إلى خفوت التكتل البشري والنزوح الجماعي في باقي المدن..
من اليونان إلى العالم (أنطولوجية الفكر وتحرر انتشاره)
الثورة ضد محتل في مصر:
وبعد أن تتلمذ الاسكندر على يد أرسطو دارسًا منهجية العمل الجماهيري والسيطرة على العقول الغفيرة بما يناسب احتياجها، غزا مصر، فحاول المرور من عقبات الفراعنة وجعلهم يحتفظون بما يملكون من ثقافة وحضارة وهذا ما فعله البطالمة في حكم مصر، مما سهّل دخولهم البلاد، كما جعل نفسه وفقًا لعقيدتهم إلهًا وبدلًا من أن يحاربوه عبدوه، ولكن مع توالي الحكام خفت التعامل بنفس المنهجية كما لم يعد إن الإله إلهًا ولكن النقطة الفاصلة في التحرر من سلطة العبودية لندية الحصول على الوطن من المحتل هي توسيع الفارق بين المواطن البطليمي والمصري وهذا ما أدى سريعًا لحدوث ثورة الجياع الأولى-الانتفاضة في عهد بطليموس الثالث نتيجة حربه مع الفرس في سوريا حيث دفع بالعديد من المصريين في ممر الهلاك كما استنفذ كل ممتلكات الدولة وزاد على الضرائب للمواطن المصري في مقابل المواطن البطليمي، ولكنه سرعان ما أخمدها بإصلاحات اقتصادية واجتماعية مسجله باسمه في الوثيقة الحجرية الموجودة في المتحف المصري، وقد أسفرت هذه الثورة-الانتفاضة عن العديد من المزايا منها تملك الأرض للمصريين و دخولهم الجيش كجنود.
أما ثورة الجياع الثانية-الانتفاضة كانت في عهد بطليموس الرابع فبعد انتصاره في حربه في معركة رفح بفضل تجنيد المصريين زاد حجم المصروفات مما أدى إلى إدخال تعديلات على النظم المالية لمواجهة هذه المصروفات فارتفعت الضرائب والايجارات فيقول «هارولد يل» منذ ذلك الحين وقد أخذت الثورات تنشب من حين لآخر وكان مركزها طيبة وهذا ما نجده في نقوش معبد إدفو حتى انهزم إنخماخيس المصري وقائد الثورة ضد المحتل على يد ابيفانس ابن باتور.
رغم ذلك أدت الثورة إلى زيادة وعي الجماهير التي فيما بعد ساهمت في سقوط الدولة البطليمية.
ونجد هنا ضعف الفكر الفلسفي في تحرك الوعي الجماهيري إنما هو تحرك بدافع المعيشة لا العدالة ولا الحق أو السلام إلا في عهد إنخماخيس الذي قرر الحصول على الأرض لا الفتات وبأن البطليمي محتل لا إله وأن الحق لمن يملك الأرض وأن العرض لمن يحارب من أجله -راجع مخطوطات حرب إنخماخيس وأبيفانس-
وربما هذا هو الفكر الفلسفي ضد الكيان المحتل بوعي جماهيري لا فردي في مصر آنذاك.
ومع توافد الدولة الرومانية بعد البطليمية بنفس نبرة المحتل لم تذخر جهدًا لتكون مثل مثيلتها البطليمية فقد انتهجت نفس المنهج ان لم يكن أكثر عنصرية وعنف دافعة بكل المثل الإنسانوية عرض الحائط مسجلين بشاعة ديكتاتورية ونظام حكم تكنوقراطي.
مما اضطر الفلاحون إلى الهجرة (ما تسميه البرديات بهجرة القرويين)، ومع التصحر نتيجة الهجرة شهدت مصر انخفاضًا في منسوب المياه أدى لانتشار الفقر وضعف تجارة الدولة الرومانية بعد أن جعلت من مصر مصدرًا لتداول القمح و بيعه واعتمدت بشكل أساسي عليه وبذلك ضعفت نفوذ الدولة وسقطت بسهولة مع أول حراك جماهيري داخلي ضد المحتل الروماني بوعي ثقافي لاسترداد الأرض من محتل.
منهج فلسفة الثورة ضد محتل في مصر:
وتتضح فلسفة الثورة ضد محتل بإدراك الجماهير لقوتهم واحتياجهم لوطنهم بتوحيد الهدف المعني بمعنى اللا-مساواة وضعف معرفة الكيان الخارجي بمدى ترابط واتصال الكيان الداخلي للشعب، مع فتح جبهات مضادة مختلفة تؤدي إلى تزعزع كيان السلطة وضعف سيطرته وفرض سطوته على الجماهير، كما أن العامل الأساسي هو احتفاظ المواطن بوطنه وإدراك حضارته التي لا يقدرها المستعمر كجسد تحت جسده.
المصادر:
(*)الهيولوموفية-Hylemorphisme: مصطلح مؤلف من لفظين (هيولو) وهو الهيولي و(مورفه) وهي الصورة: وهي نظرية أرسطية-مدرسية تفسر تكون الاجسام بمبدأين أساسين متكاملين هما المادة والصورة. - نظرية أرسطو السياسية – موسوعة ستانفورد الفلسفية ترجمة محمد الرشودي. -السياسة لأرسطو – المركز العربي للأبحاث والسياسات -السياسة – أرسطو -الأخلاق النيقوماخية – أرسطو -ما بعد الطبيعة والفيزياء – أرسطو -الأخلاق والسياسة – أرسطو -قاموس الآثار الكلاسيكية للوبكر - عن أرسطو -رؤيا المأمون وما قاله أرسطوطاليس -أعظم الفلاسفة – ماك ليسش -فكرة الإله عند أرسطو – مؤمنون بلا حدود -محاضرات في الفلسفة اليونانية – د/ منى عبدالرحمن -قاموس ناثان الفلسفي – أندريه روسيل -الجمهورية – أفلاطون -الأمير – مكيافللي -تاريخ مصر تحت حكم البطالمة – ادوارد موكسوم -البطالمة ومصر -وثائقي الاسكندر المقدوني – ناشيونال جيوجرافيك -موسوعة مصر القديمة الجزء السادس عشر -ثورات المصريين – فاروق عطية -دراسة تحليلية في أوراق البردي – رسالة هيثم محمد عبدالعليم من جامعة حلوان ٢٠٠٣ https://www.academia.edu/35676718/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9 -ثورات الجياع – د/صلاح
كتابة وإعداد: مهند جمال انسان
مراجعة علمية: عصام أسامة
تصميم الغلاف: حسين عامر
تحرير: هدير جابر



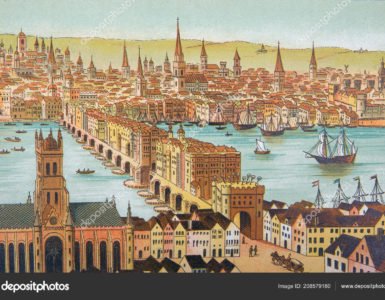


إضافة تعليق